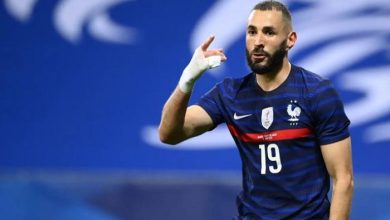الولايات المتحدة تفكك سلاسلها التجارية بنفسها في عصر العولمة

في غضون أشهر قليلة، أحدثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحولًا جذريًا في سياسات التجارة الأمريكية.
وذلك عبر فرض تعريفات جمركية شاملة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين تراوحت بين 10% و50%، شملت قطاعات استراتيجية مثل الفولاذ والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار. وبهذه الإجراءات، ارتفع متوسط التعريفات الفعلية إلى نحو 18%، وهو المستوى الأعلى منذ قرن تقريبًا.
وقال تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز إن ترامب يبرر هذه السياسة بمنطق قومي واقتصادي في آن واحد؛ فهو يرى في الرسوم وسيلةً لتحقيق فائض مالي داخلي، ولإعادة تنشيط القاعدة الصناعية الأمريكية بما يدعم في نهاية المطاف القوة العسكرية للبلاد. وبحسب رؤيته، “تحميك الحروب الاقتصادية بقدر ما تحميك الدبابات”.
ثمن مرتفع
لكن هذه السياسة الحمائية تأتي بثمن اقتصادي مرتفع. فبعد نصف قرن من الاندماج العميق في سلاسل الإمداد العالمية، أدت العولمة الصناعية إلى رفع إنتاجية الشركات الأمريكية وتحسين جودة السلع وخفض الأسعار. أما فك الارتباط بهذه الشبكات، كما تفعل التعريفات الجديدة، يعني ارتفاع التكاليف وتراجع القدرة التنافسية، ليس فقط في قطاع السلع الاستهلاكية بل أيضًا في الصناعات الدفاعية الحساسة.
إذ سيضطر المقاولون العسكريون إلى دفع أسعار أعلى للمواد الخام، ما يرفع تكاليف الإنتاج ويقيد قدراتهم التصديرية، خصوصًا مع ميل الحلفاء إلى تنمية صناعاتهم الدفاعية المحلية وتقليص الاعتماد على المورد الأمريكي.
وتؤكد المؤشرات الاقتصادية المبكرة أن النتائج ليست مشجعة. فوفقًا لمعهد إدارة الإمدادات (ISM)، انكمش قطاع التصنيع الأمريكي لستة أشهر متتالية، بينما فقد نحو 78 ألف عامل وظائفهم في الصناعة خلال عام واحد. ومع أن العجز التجاري في السلع انخفض جزئيًا بسبب تراجع الواردات من الصين، إلا أن الصادرات استقرت دون نمو، ما ساهم في ضعف أرقام التوظيف. في المقابل، ارتفع التضخم، إذ انعكست الرسوم الجمركية على أسعار السلع المستوردة والمحلية على حد سواء، لاسيما أن نحو 45% من الواردات الأمريكية هي مدخلات إنتاج أساسية في الصناعات المحلية.
الرد العالمي
في النطاق العالمي، لم يتأخر الرد. فالشركاء التجاريين التقليديين للولايات المتحدة—الاتحاد الأوروبي، الهند، البرازيل، الصين، وحتى المملكة المتحدة—سارعوا إلى إعادة توجيه سلاسلهم التجارية وتوقيع اتفاقات جديدة تقلل اعتمادهم على السوق الأمريكية.
أما الاتحاد الأوروبي فهو يتفاوض مع الهند وإندونيسيا، ويحيي اتفاق “ميركوسور”، وينظر في الانضمام إلى “الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ”. بهذه التحركات، تتجه بنية التجارة العالمية نحو تعددية قطبية متحررة من الهيمنة الأمريكية.
ورغم أن بعض الاستثمارات الأجنبية قد تتدفق إلى السوق الأمريكية للاستفادة من ارتفاع الأسعار المحمية بالتعريفات، إلا أن تكاليف تأسيس المصانع والبنية التحتية سترتفع بسبب زيادة أسعار الفولاذ والنحاس ومواد البناء، ما قد يثني المستثمرين الجدد. كما أن المنتجات الأمريكية، مع ارتفاع أسعارها، ستفقد ميزتها التنافسية في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يضعف الصادرات الأمريكية على المدى المتوسط.
قطاعات هامة
ويمتد أثر هذه السياسات إلى قطاع الدفاع الذي طالما اعتمد على سلاسل إمداد دولية. وتاريخيًا، كانت الولايات المتحدة تستورد معادن إستراتيجية مثل النيكل والمنغنيز من الخارج حتى في أوقات الحرب. وفي العصر الحديث، تعتمد الشركات الدفاعية الكبرى على شبكات توريد تمتد من اليابان وكوريا الجنوبية إلى أوروبا وأستراليا. وليست هذه الروابط تجارية فقط، بل تقوم على شراكات بحثية وتكنولوجية طويلة الأمد، مكّنت الصناعات الأمريكية من الابتكار السريع وخفض تكاليف الإنتاج. وقطع هذه الشبكات أو إضعافها، كما تفعل سياسة “التعريفات الشاملة”، يقلل من مرونة الصناعة الدفاعية ويجعلها أكثر عرضة للأزمات الداخلية.
عزلة اختيارية
والنتيجة الأبرز، بحسب التحليل، هي أن الحلفاء بدأوا فعلاً في مراجعة اعتمادهم على السلاح الأمريكي. ففرنسا تدعو أوروبا إلى “الشراء الأوروبي”، والدنمارك وإسبانيا فضّلتا أنظمة دفاعية أوروبية على نظيراتها الأمريكية. كما تقيّد المفوضية الأوروبية استخدام صندوقها الدفاعي الذي تبلغ قيمته 176 مليار دولار بالشركات الأوروبية فقط، ما يستبعد المقاولين الأمريكيين. وحتى في آسيا، تتجه اليابان وكوريا الجنوبية نحو تطوير صناعات دفاعية محلية، مدفوعةً بتصاعد نزعة الاعتماد الذاتي وتراجع الثقة في استقرار السياسة التجارية الأمريكية.
وفي ظل ذلك، يبدو أن “القلعة الاقتصادية” التي يسعى ترامب لتشييدها قد تؤدي إلى نتائج عكسية: اقتصاد أقل تنافسية، وحلفاء أكثر استقلالًا، وصناعة دفاعية أقل قوة. فالاقتصاد الأمريكي، مهما كان ضخمًا، لا يستطيع بمفرده إعادة إنتاج مزايا التخصص والتعاون التي توفرها سلاسل التوريد العالمية. وحتى الصناعات ذات الطابع الأمني تحتاج إلى مدخلات أجنبية، سواء كانت رقائق إلكترونية أو معادن نادرة تستخدم في الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة.
ويخلص التحليل إلى أن الحل لا يكمن في الانعزال التجاري بل في إعادة هيكلة العولمة على أسس آمنة. ويمكن للولايات المتحدة أن تفرض رسومًا انتقائية تقتصر على الصناعات ذات الحساسية الأمنية، وتخفف القيود عن الشركاء الموثوقين في أوروبا وآسيا، فيما يُعرف بسياسة “الصداقة الإنتاجية” (Friend-shoring). كما أن الدعم الحكومي الموجه يمكن أن يعزز قدرات القطاعات الحيوية، مثل أشباه الموصلات والمعادن النادرة، دون الحاجة إلى حرب تجارية مفتوحة.
وحيث تشير التجربة إلى أن الاعتماد المتبادل المدروس—وليس الانعزال—هو مصدر القوة الأمريكية الحقيقي. فإن الانفصال عن شركاء موثوقين يضعف الاقتصاد ويقوض القدرة الدفاعية، بينما التعاون المتوازن مع الحلفاء يوفر الابتكار والموارد والمصداقية الاستراتيجية التي بنت بها الولايات المتحدة تفوقها لعقود. لكن سياسات ترامب التجارية، رغم نواياها المعلنة لحماية “أميركا أولاً”، قد تجعلها في الواقع أقل ثراءً وأقل أمانًا في عالم تتسارع فيه المنافسة الصناعية والتكنولوجية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز